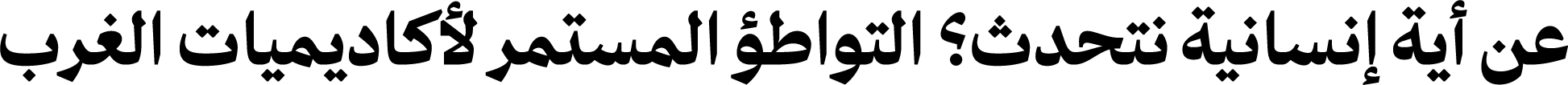
بقلم سنابل عبد الرحمن
ترجمة إبراهيم بهاء الدينيُعد البحث حول مفهوم الاستشهاد أو الشهادة موضوعًا مثيراً في الأكاديمية الغربية. المئات من الكتب والأوراق البحثية تتناقش شعريات صور الاستشهاد، وتتبع إنعكاساته في الأشكال المختلفة المتمثلة في الملصقات والأفلام والخطابات والجرافيتي والمخيلة الشعبية. فعلى سبيل المثال، العلاقة التي بناها الشاعر الفلسطيني محمود درويش بين شخصية الشهيد وتقديمه للأرض على أنها حبيبة يجب المقاومة من أجلها هي موضوعات يتم الاحتفاء بها وتُبحَث على نطاق واسع. لكن على صعيد آخر، شعر درويش، المُلقب بــ‹شاعر المقاومة›، غالبًا ما يُفرغ من دلالاته الثورية العميقة وتشعباته السياسية، ليبقى منه أصدافًا من اللغة الجمالية والكنايات الشعرية الفريدة – كعالم من الإسقاطات الغرائبية. ا
تعمل الأكاديميا الغربية على انتزاع مفهوم الشهادة من جميع سياقاته باستثناء سياق الحياة والموت. في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا أو أي مواقع أخرى تتمكن السيطرة البيضاء، العرقية منها أو الفكرية، من فرض نفسها، حيث تبحث الأكاديميا في تأويلات الموت والحب والشعر والتعددية والتضحية والنبل والانضباط والتحرر والالتزام. دون النظر إلى الكيان الكولونيالي الاستيطاني الإسرائيلي، ومايفرضه على الأرض، حين يتم تناول مفهوم الشهادة الفلسطينية وتحققها المأساوي. بالتالي، يتحول الشهيد الفلسطيني إلى كيان مجرد يثير فضول وولع الأكاديميا الغربية حول هذا الزمكان المشوش الذي يتمكن فيه الإنسان من تقبل الموت – الفناء التام لوجوده – كثمن لحياة كريمة لفلسطينيين المستقبل. يصبح الشهيد الفلسطيني شيئًا مستحيلًا، إنجاز غير مفهوم، بينما يتم حصره في اطارات اللاحقيقي واللامفهوم للوجود والعدم. في بادئ الأمر، نادرًا ما يُنظر إلى الشهيد الفلسطيني في الأكاديميا الغربية كإنسان من شحم ولحم، وبذلك، لا يعتبر موته، موت إنساني. وفقًا لتلك المخيلة البيضاء، فإن الاستشهاد الفلسطيني يكون مجرد نتاج خيال غرائبي أو فعل إرهاب مروع. ا
إن المخيلة الغربية ترتبك تمامًا من فعل الشهادة. فهي بخليط من الفضول والنفور والغيرة تطالب بفهم ذاك السؤال: ما الذي قد يدفع الآف الفلسطينيين للتضحية بأجسادهم لأجل قضية؟ الإجابة هنا ليست في إضفاء طابع رومانسي على سؤال وجودي، ولا التطلع إلى شاعرية ما بعد الموت، وبالطبع هي ليست محاولة انتحارية لوضع حدًا للألم. الشهادة، ماهي سوى تكلفة الوقوف شاهدًا على ألم عظيم. وأعظم الآلام، هو غياب الحرية. التبعات المؤلمة لأشكال الشهادة المختلفة التي شاهدناها على الأراضي الفلسطينية تكشف عدم اهتمام، بل نفور وارتباك،الغرب من تكرارها. فهي تعكس جُبن الغرب من تسمية الجاني، ورفضه الاعتراف بالفظائع التي ارتكبها، وتواطؤه في غض الطرف عن دموية الإبادة الجماعية. ا
مقطع الفيديو الذي خرج فيه أب غزاوي من سيارة حاملًا بيديه أكياسًا بلاستيكية بداخلها أشلاء طفله المحروقة، سيلاحق ‹الإنسانية› إلى نهاية التاريخ. ذاك المقطع، وآلاف غيره، يَبِثُ شكلًا من أشكال الإستشهاد الجزئية داخل كل فلسطيني لاجئ أو في المنفى يشاهد عن بعد. الخوارزميات المحمولة في الأيدي، تبث صورًا حية لأشلاء تتناثر من مذبحة جارية في حق أمة بأكملها، بينما يُحرض الغرب والحكومات العربية المتورطة على المذبحة، أو على الأقل يتواطئون. ليتحول المحيط المادي للمشاهد الفلسطيني إلى مجرد واجهة، وتصبح الخوارزميات هي العالم الحقيقي الوحيد بالنسبة له، وتنتزع الروح من جسد المشاهد. فيتظاهر الفلسطيني -لاجئًا كان أم منفيًا- بعيش يومه، بينما تُفرض عليه المذبحة رقمياً، ربما يتذكر صدفة أن يأكل، أو يتذكر كيف يقود سيارته، كما قد يتفوه حتى ببعض الكلمات. لكنه وبلا شك، قد استُشهد شيئًا داخله أو داخلها. ا
الاستشهاد الفلسطيني، بجميع أشكاله، يحدث في إطار افتراضات استشراقية، جامعة، من شأنها التشهير. لعصور، كان التطبيق العملي للاستعلاء الأبيض يرفض النظر للفلسطينيين والعرب عمومًا على كونهم بشر. الفلسطيني، في أحسن الأحوال، يُنظر إليه على أنه هجين، «حيوان بشري»، كما تؤكد القيادات الإسرائيلية قُبيل إعدام هذا المخلوق الهجين. يذكرنا هذا بتصريح وزيرة الداخلية الإسرائيلية أيليت شاكيد بأن كل الفلسطينيين الرضع هم «ثعابين صغار» يجب قتلهم قبل أن يكبروا ويصبحوا إرهابيين. ا
تظهر الوجوه البيضاء على الشاشة، ساخِطة مُحْمَرّة لما عليها من تذكير الفلسطينيين، مرة تلو الأخرى، أنهم حيوانات بشرية حقها الوحيد هو الموت بصمت. ترفض رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين -ساحرة البحر الشريرة في الحياة الواقعية- تقديم أية مقابل لاغتصاب الأصوات الفلسطينية، والأرواح الفلسطينية. بينما يؤكد وزير الدفاع الإسرائيلية يوآف غالانت، بنفس السخط أنه لن يكون هناك كهرباء ولا غذاء ولا ماء ولا طاقة. تقوم المعاهد الثقافية في برلين بــ«الترحيب بالمهاجرين» و«استضافة الحفلات» و«تناول الطعام النباتي» و«مشاركة للشقق السكنية» و«ردع النازية»، بينما تطلي صفحاتها بالأبيض والأزرق، ليس فقط إعلانًا لدعمهم لإسرائيل، ولكن توقعًا منهم بأن يشارك أعضاء هيئة التدريس والعاملين والموظفين في الإبادة الجماعية. ا
الوجوه الساخطة جميعها واحد. هي وجه الرجل الأبيض حين يجرؤ «الحيوان البشري» على المقاومة. ذلك الذي طالما ركله وضربه وجوعه وعذبه وحبسه وأصابه واغتصبه وسرقه وطعنه وأعماه الرجل الأبيض. يُخفي ذاك السخط غيظ الرجل الأبيض من خسارة فرصته لاستمرار ممارساته السادية تجاه ذاك الحيوان البشري. يغضب الوجه الأبيض من عدم قدرته على متابعة الانتشاء من ممارسة العنف على ذاك «الحيوان البشري» الهجين فاقد الوعي. يوحي سخط السياسيين الغربيين الملتهب بالنفور الجمعي من رؤيته يقاوم. ا
يُشير الفيلسوف الفرنسي الجزائري فرانز فانون لردة فعل الجانب الفرنسي الساخط على المقاومة الجزائرية. «متى اختار السكان أن يواجهوا العنف بالعنف…فإنهم يلاحظون ملاحظة مباشرة أن جميع الخطب التي تلقى عن المساواة بين كل البشر، ومهما تكدست فوق بعضها البعض، لا يمكنها أن تُخفي الحقيقة الوقحة، وأن الرجال الفرنسيين السبعة الذين قتلوا أو جرحوا في كمين مضيق ساكامودي، أثاروا استنكار الضمائر المتحضرة، بينما لم يعبأ أحد بتدمير قرى جرجورة وجرة الجزائرية ولا بمذبحة السكان»1. ا
وبينما يجب أن يكون دور الإنسانيات في الأكاديميا اليوم حاسماً، ومتكاملاً، نشهد نقيض ذلك. فالبعض أسرع للدفاع عن العلوم الإنسانية كمجال، بحجة أن هذه المجالات هي ما تدافع عن جميع العلوم الإنسانية وهي التعبيرات الأكثر حيوية عن الحياة البشرية بشكل عام. وقد يجادلون حتى بشأن قدسية العلوم الإنسانية وضرورة بقائها غير سياسية. وهذا مثالي لمن يتلقى الثمار الناتجة من الاستغلال الغربي، وخاصة من لديهم امتيازات اختيار تسييس أو عدم تسييس الفلسطينيين، بينما الفلسطينيين أنفسهم يختنقون. لكن الجامعات الغربية لا تدعي الحيادية في هذه اللحظة قاطعة الوضوح حد التبجح. في الواقع، الجامعات والمعاهد الثقافية الغربية، وغيرها من الأماكن التي تحتفي بالإنسانية هم في طليعة المبررين وملتمسي الأعذار للإبادة الجماعية المتواصلة، بل وأيضًا يدافعون عن ضرورة استمرارها. ا
جامعة برلين «الحرة»، التي تضم عددًا مذهلًا يزيد عن ثلاثين ألف طالب، أعلنت صراحةً وقوفها إلى جانب إسرائيل. ليس هذا فحسب، بل نشرت «خلال هذا الوقت العصيب، نطلب من جميع أعضاء جامعتنا إظهار التضامن مع أصدقائنا الإسرائيليين». لم يظهر الفلسطينيون في تصريحاتهم ولو لمرة واحدة. في برلين، أصدرت المقاهي والمسارح والمساحات الثقافية وقاعات الموسيقى والمطاعم والمعارض وغيرها من الأماكن التي تهدف أساسًا إلى تبادل التجربة «الإنسانية» تصريحات مماثلة تم فيها محو الفلسطيني بالكامل أو شيطنته أو بشكل متناقض، شيطنته ومحوه. ا
عقب إحدى المجازر الشنيعة -الكثيرة- التي تشهدها غزة، عُقد اجتماعًا لمجموعة تابعة لإحدى الجامعات الألمانية، تحت إشراف هيئة ألمانية بيضاء بالكامل. شدد المتحدثون على الحاجة «للحوار» الذي يوظف «استخدام المهارات العلمية المكتسبة من الممارسة الأكاديمية» للنظر إلى ما هو أبعد من «الاستقطاب». ثم انتظروا بوجوه متوترة حتى يروا إذا ابتلع الحاضرون الطُعم، إذا استوعبهم ذلك الخوف، تلك الفوبيا الفلسطينية، ذلك «الذنب» الألماني، إذا تغلب عليهم الصمت. هذه هي آلية عمل الماكينة الكولونيالية. تكشف هذه المواقف الجبانة هيكلها، حيث يُطالَب الفلسطينيين والطلاب المهاجرين بابتلاع حناجرهم، بعد أن حاضَرهم المتحدثون ذاتهم لعشرات السنين حول الفن والأدب العربي، الآن يتفكك اللحم الذي يغطي آلة الحرب الاستعمارية. لتتوهج الآلة في وميض مضاد للرصاص: متواطئة ودامية وبيضاء دائمًا. ا
وهكذا تجري إعادة تعرية للمستشرق التقليدي، الذي لم يختف أبداً، حتى وإن اعتبرنا ذلك مشهداً نادراً. لكن ماذا عن الأكاديمي الغربي المتحدث بالعربية؟ الذي عاش في الوطن العربي، وينشر عن الثقافة والسياسة العربية؟ ذلك الذي يناقش فرانز فانون مع طلابه على مائدة الغداء، ويوعظ بمواجهة القوة بكلمة الحق؟ الذي يُدرِّس مناهج حول الاستشراق مرة تلو الأخرى، الذي يعتلي مناصب مرموقة في الجامعات العربية والغربية، الذي عانَ طلابه من الحروب، الذي ينشر أبحاثًا علمية كتهنئة ذاتية حول «أدب المقاومة»، الذي بنى حياته المهنية بالكامل على معاناة الفلسطينيين وشعوب عربية أخرى كموضوعات للفضول الأكاديمي، الذي ينتقد الإلحاحات الكولونيالية وتطبيقاتها، والذي تجده اليوم في سبات عميق؟ بل أحيانًا أسوأ، تجده اليوم يقدم أنصاف تصريحات فاترة مدافعة. إذا قرر يومًا الخروج عن صمته، فما هو إلا ليشير إلى ذاك الألم المبهم الغامض الذي لَحِقَه بعد مشاهدة ما يحدث في العالم. ا
وفي اللحظات النادرة التي يدركون بها ازدواجيتهم، يحاولون اخفائها عن طريق نثر غبار «التعايش» في الهواء ككلام: نظري، منزوع السياق، أناني وتافه. بينما، الحرب تستمر خلف واجهات «التعايش» والتطبيع الرقيقة. قد تكون باردة، يتم خوضها في الفضاء السيبراني الذي يتسع بلا حدود في نفس اللحظة التي يضيق بها على الأصوات الفلسطينية، فيراقبهم ويخنقهم، أو في الاجتماعات الأكاديمية التي تطرد أعضاء هيئة التدريس الذين يتجرأون على أنسنة الفلسطينيون. كما قد تكون حارقة، تقتل آلاف الأطفال الفلسطينيين المذعورين الذين يأويهم آباؤهم بينما يشاهد العالم كما يحدث اليوم. ا
ما هو سبب هذا «الانزعاج» الغامض؟ ما هو أصل هذه الإبادة الجماعية الجارية التي حتى لن يسمونها باسمها الحقيقي؟ لماذا تم نبذ إدوارد سعيد؟ أين ولد محمود درويش؟ لماذا تم أرشفة ملصقات النضال الفلسطيني؟ كيف مات غسان كنفاني؟ كيف كانت ردة فعل جامعاتهم على الغزو الروسي لأوكرانيا؟ ما الذي يرهبونه؟ ما الذي يرهبونه؟ ما الذي يرهبونه؟
الرجل الأبيض، «ابن النور»، الذي يحارب الفلسطيني، «ابن الظلام»، دفاعًا عن «الحضارة» ضد «قانون الغابة»، يفتح المجال لتعريف مصطلحين مثيرين للخطاب الغربي: «الإنسانية» و«الحضارة». وكلاهما يتجذر من أسس التطبيق الاستشراقي والاعتذاري: هل تمتد مظلة الإنسانية التي يعاد إنتاجها ويتشاركها الأكاديميون في الغرب لتشمل الفلسطينيين وغيرهم من العرب؟ ما هي الآثار القاتلة للإصرار على الطبيعة «غير المتحضرة» لهؤلاء الفلسطينيين؟
بسبب عدم اشتمالها في «إنسانيات» الغرب، تتحول الذات الفلسطينية إلى «ابن الظلام». ويتولى مستشرقي الغرب طواعية الدور المنسوب عادة إلى السياسيين ووسائل الإعلام الرئيسية والمتحدثين الرسميين والجنود: ويمنحون أولوية إنسانية لمجموعة ما، ضد الأمة «الغرائبية البعيدة»، «الخاضعة للانقراض»، على المستوى الجسدي والميتافيزيقي. وربما يبتلع الأكاديميون الغربيون صوتهم المهتز خوفًا على مناصبهم الأكاديمية ومسيراتهم المهنية ورواتبهم المستقبلية ومكانتهم الاجتماعية. إلا أنه يوجد، على الأغلب، مكافأة أكبر لهذا التواطؤ. يوجد على الأرجح شعور أكبر بالأهمية الذاتية والإدراك الجماعي. ولعله إصرار جماعي من جانب المعاهد الأكاديمية الغربية على إبقاء «الشرق الأوسط» على مسافة بعيدة حتى يتمكنوا من الاستمرار في دراسته عن بعد، وان يغرسوا يوتوبيا وحلم وجنة استشراقية في جغرافيات وأجساد وآداب أبناء الظلام هؤلاء. ربما لأن فلسطين المحررة، العالم العربي المحرر، لن يكون فيه شيء غرائبي، ولا شيء بشع، ولا شيء محدود الإتاحة، ولا شيء يشبه الحلم، ولا شيء كابوسي، ولا شيء مثير للشفقة، ولا شيء تنكيلي، ولا شيء إجرامي، ولا شيء بعيد المنال حتى يستحق الدراسة بالنسبة إليهم. ا
وبالتالي فإن الجزء الكبير من الأوساط الأكاديمية في الغرب ينهار بشكل قاطع. إنه يثبت في هذه المرحلة الحرجة من التاريخ التحرري ومناهضة الاستعمار، أن أهدافه الوحيدة هي: التجميع والأرشفة والتعداد والتكديس والاجترار وإعادة الإنتاج وشغل المزيد من المساحة. وفي الوقت نفسه، يُمنح هؤلاء الأكاديميين رواتب أكبر، مناصب أعلى، خطط تقاعدية، ومكانة اجتماعية وهمية ينافسها الفكر الشعبي وينتصر عليها بسهولة. لقد أدى صمتها المتهاون والمميت إلى إفراغ مصطلح «إنهاء الاستعمار» بالكامل. وتحول إنهاء الاستعمار في تلك السياقات الأكاديمية إلى قوقعة خاوية، حشو فراغ، اتجاه احتياطي، كلمات لفتح المحادثات، وأحيانًا وسيلة لتهنئة الذات. إنه لا يحاول استجواب الإنسانية البيضاء أو الأخلاق البيضاء وفوق كل شيء العمى الأبيض، الذي يقتل. يجلس في الزاوية ويراقب حتى يتم إزالة الجثث الفلسطينية المقطوعة وتنظف الدماء وتقدم التقارير إلى الطاولة. ثم، بعد سبات طويل، تعود الأوساط الأكاديمية في الغرب إلى التجميع والأرشفة والتعداد والتكديس والاجترار وإعادة الإنتاج وشغل المزيد من المساحة. ا
في هذا المنعطف من الاضطرابات المؤلمة، يستمر تداول بيان مفاده أن «التاريخ لن ينسى أولئك الذين وقفوا مكتوفي الأيدي». وهذا يعني أن المتفرجين والمتلصصين والمتسكعين والمستشرقين سوف يستيقظون مجتمعين ذات يوم بضمير متألم. أو ربما سيفعل ذلك أبناؤهم وأحفادهم. وليس على المرء سوى النظر لألمانيا، ونزعها الإنسانية عن كل ما هو فلسطيني، ليرى كيف يتحطم هذا التصريح تمامًا. ما على المرء إلا أن ينظر إلى جنوب أفريقيا، واستعمار الموارد المستمر من قبل المستوطنين البيض «السابقين». ما على المرء إلا أن ينظر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وما بها من عنصرية وإبادة بيئية وفقر واستهلاكية مسعورة. لم يستيقظ أي مستعمر بضمير متألم ابداً، بل لم ينم أياً منهم ابداً. ا
كيف يمكن لهؤلاء العلماء أنفسهم أن يستمروا في إلقاء محاضراتهم حول «إنهاء الاستعمار» بينما يراقبون بهدوء الإبادة الجماعية للفلسطينيين المستمرة حتى اليوم؟ كيف يصدقون أي كلمة تخرج من أفواههم في هذا الصدد أو غيره؟ فكيف يمكنهم صياغة مقترحات حول شيء ثبت لهم عدم وجوده؟ ما هو الحل لهذا التشوه الكامل وانهيار ممارسة العمل الأكاديمي ذاته وانتشاره؟ وفي خضم هذا العنف المروع ضد الفلسطينيين والصمت المروع بنفس القدر من جانب الأكاديميين في الغرب، لا تكمن الإجابة على هذه الأسئلة الصعبة في إنكار الأكاديميا، بل في نوع من التحول المتعمد الذي يصطدم ببياضها وتواطئها. من الممكن إنقاذ الأكاديميا في هذه اللحظة وتداعياتها من خلال كسر أغلال الهيمنة المؤسسية ودفع العمل الأكاديمي إلى خنادق الممارسة. ا
لا يمكن لهذا أن يحدث إلا إذا اجتمع أولئك الذين يعانون من التطبيق الانتقائي للإنسانيات في الغرب وقاموا بإدراج أدوات الأكاديميا في المساحات غير الأكاديمية: جعل فكر الأكاديميا ونظرية إنهاء الاستعمار في متناول الناس خارج أسوار الجامعات وتوظيف المساحات السيبرانية، على نطاق أوسع، لنشر رسائل المثقفين بشأن الحرية. وأيضًا، تنظيم الدورات التعليمية، وإتاحة الموارد للجمهور، على أن تشمل الأفلام والأعمال الفنية والتاريخ الشفهي والأفلام الوثائقية ورسوم الجرافيتي،والموسيقى الشعبية والمحادثات اليومية حول التضامن كمواد تربوية. ويتضمن ذلك أيضًا الاحتجاج وصياغة العرائض والتنظيم والكتابة والمناظرة والتحدث إلى الآخرين بحماس وشغف التحرر الفكري والحرية. ا
يمكن للأكاديميين أن يتعلموا الكثير من نظريات الشاعر الفلسطيني الشهيد غسان كنفاني حول أدب المقاومة؛ ويمكنهم حتى تطبيقها. ويمكن استخدام قصائد المقاومة والقصص القصيرة والروايات والنصوص التجريبية والروايات القصيرة والمسرحيات ونصوص الملصقات ونصوص المعارض لتحقيق ذلك. نصوص تصر على ضرورة الحفاظ على الأمل، ومقاومة محو وإبادة الفلسطينيين، ومحبة ذوينا في لحظات الألم، وتوسيع نطاق تضامننا، و تحرير أنفسنا من عذاب هذه الأرض، لتحقيق التحرير، لنحيا، فقط لنحيا. فقط لنحيا! ا
ولعل أعنف ما شهدته البشرية على الإطلاق هو التبلور المطلق لإنسانيات الغرب البيضاء: أحلام الرجل الأبيض في اليوتوبيا المطهرة، وهوسه بالتملك: استعباد الأجساد ونهب الأشياء واستعمار الأرض وأرشفة الذكريات وسرقته للخطاب حول إنهاء الاستعمار واستهلاكه القاتل، وتلقينه للطلاب حول حدود الإنسانية وعدم إمكانية اشتمالها لأبناء الظلام. ا
يمكن الآن سماع صوت فرانز فانون، المحاور المحبب إلى آلاف الفلسطينيين في هذه اللحظة المظلمة. «وفي مرحلة ثالثة، مرحلة أخيرة تسمى مرحلة المعركة، نرى الإنسان ضحية الاستعمار بعد أن حاول أن يفقد نفسه في الناس ومع الناس، يعمد إلى عكس ذلك، فهو الآن يهز الناس. إنه الآن بدلاً من أن يغفو غفوتهم، يحول نفسه إلى موقظهم. إنه الآن ينتج أدب معركة، ينتج أدبًا ثوريًا، أدبًا قوميًا. خلال هذه المرحلة، يشعر عدد كبير من الرجال والنساء الذين لم يفكروا ابداً في إنتاج عمل أدبي، بالحاجة إلى التحدث إلى أمتهم، وصياغة الجملة التي تعبر عن قلب الشعب، وأن يصبحوا لسان حال الشعب. لأن يكونوا الناطقين بلسان واقع جديد، واقع يتحقق»2.ا
المصادر ا1 فرانز فانون، «معذبو الأرض»، (القاهرة: مدارات للأبحاث والنشر، ٢٠١٥ [صدرت الطبعة الأولى عام ٢٠١٤])، ترجمه إلى العربية سامي الدروبي وجمال الأتاسي، ص ٨١.ا ا2 فرانز فانون، «معذبو الأرض»، ص ١٨٠.ا
سنابل عبد الرحمن،
حاصلة على درجة الدكتوراه في الدراسات العربية، وتركز على الواقعية السحرية في الأدب الفلسطيني. هي كاتبة باللغتين العربية والإنجليزية وتنشر مقالات تنتقد فيها الفن والأدب على منصات منها «فصحة»، «الأخبار»، «حبر»، «جدلية»، و«نو نين». تستخدم سنابل النصوص والصور لتحقق قراءة للواقع المادي من أجل ابتكار سبل مواجهته. في الأوراق الأكاديمية والنصوص الأدبية والتصوير الفوتوغرافي للأفلام، تبحث في إمكانات الأدب في تحويل الخيال إلى واقع معاش.ا
